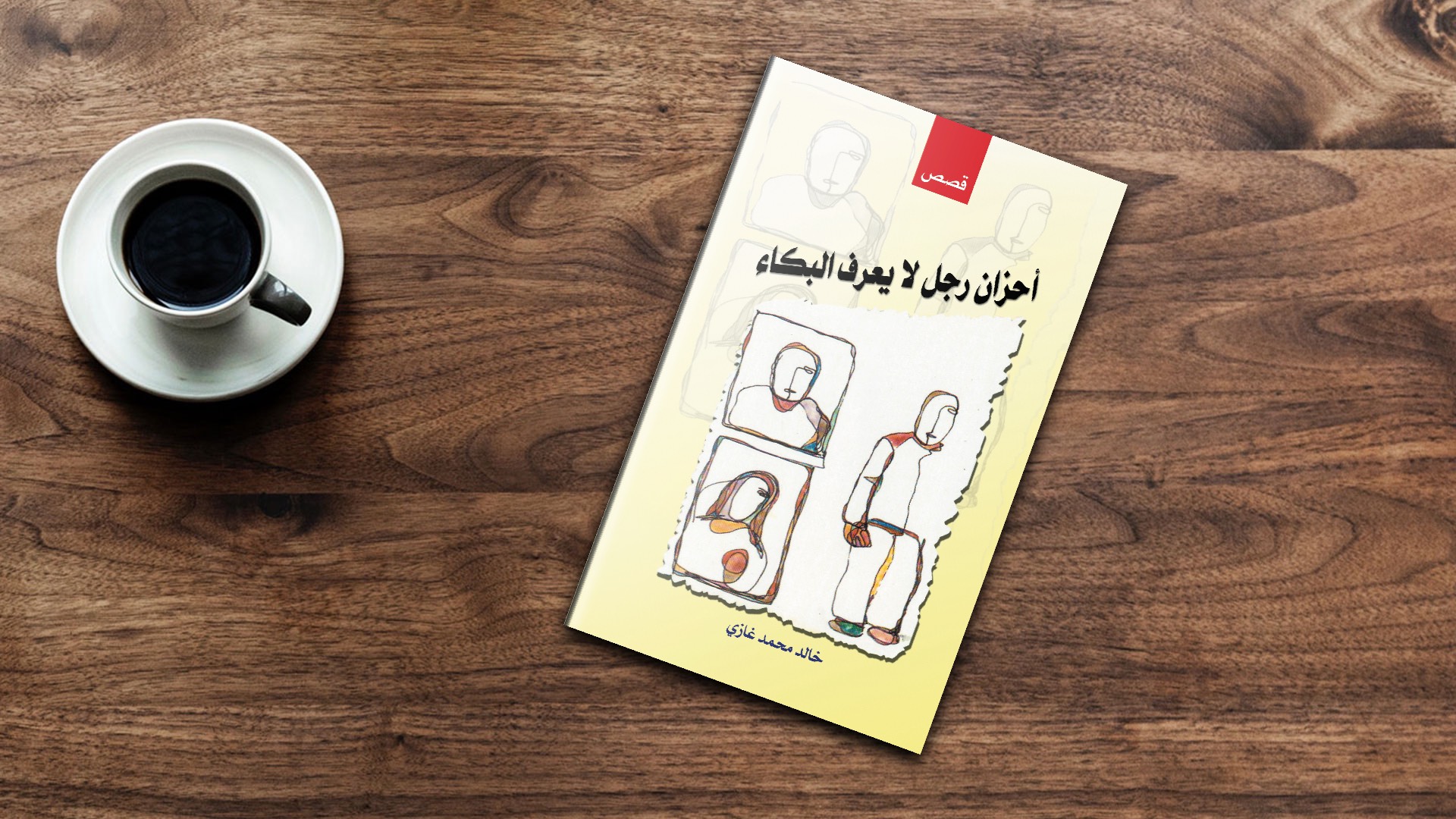
تتنوع تجارب قصص “أحزان رجل لا يعرف البكاء” للقاص خالد محمد غازي بين القصة القصيرة والأقصوصة، وتضم المجموعة بين ضفتيها اثني عشر عملاً إبداعيًا. كُتبت هذه القصص في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1989، وقد نشر القاص قصص تلك المجموعة متفرقة في الدوريات العربية.
الإنسان البسيط هو محور قصص هذه المجموعة. ربما يكون هذا الإنسان البسيط في أي مكان، في مصر مثلاً، أو في لبنان، أو في أي قطر عربي أو أجنبي. المهم أنه إنسان بسيط، تتجلى أزمته الحقيقية في صراعه الحاد بين المثال والواقع، وهمومه الذاتية تسعى لتجاوز واقعه المهترئ نحو عالم القيم، وتجسد الحلم في التغيير إلى ما هو أفضل.
ويمكننا من خلال قراءة هذه المجموعة أن ندرك خصائص هذه القصص من ناحية الرؤية والأداة والتقنية الفنية. تتسم رؤية القاص بالمثالية والروح الشفافة التي تتجاوز الواقع المادي بتراكماته الهائلة من الضرورات التي تمسك بخناق الإنسان وتكاد تعصف به، في البيت حيث مطالب الزوجة والأولاد، والعمل حيث النفاق الاجتماعي، والصداقة الخالية من المبادئ التي تؤثر على المداراة والتملق. ولكن الشخصية تحتفظ ببراءتها ونقائها المتعدد الألوان، ويبقى الإنسان/الشخصية مخلصًا للطهر والشرف والكرامة. ويستمر الحلم مستشرق البداية من جديد في كل مرة أقول فيها لنفسي: “أبدأ من جديد، وأبدأ من جديد. واليوم أقول لنفسي: لماذا لا أبدأ من جديد؟” ولكن، هل كان أناس العالم سيبدأون من جديد؟ انظر قصة “أحزان رجل لا يعرف البكاء”.
ورغم الظروف القاسية التي تحيط بالشخصية، إلا أنها تشق طريقها بإصرار غريب وتحدٍ مثالي، حيث حبيبته التي خانته، ولم ينتقم منها، وحيث الظروف الصعبة التي لم يرضخ لها. انظر (أحزان رجل…) “لقد عشت على أفكاري، لا أريد أن تزعزعني أي ريح، أيًا كانت. يوم أحاطت بي الكلاب من كل النواحي، تريد افتراسي، تركتني وحدي بين مخالب مجهولة، كنتُ أراك في سجني وفي عينيك شماتة غريبة: النضال من أجل المبدأ، حتى وصل بك المبدأ إلى الاعتقال، إلى السجن” انظر ص 13.
وهذه المثالية تجدها في كثير من قصص المجموعة، منها قصة “المارد الذي مات”. فبطل تلك القصة يطارد الشر في كل مكان، متمثلاً في ذلك الوجه البشع الذي يجعله يصحو فزعًا من نومه ويجره إلى بئر مرعبة وينطلق به عبر بيداء لا نهاية لها. يقول “أحيانًا أخاف، أضعف، أهتز، أنزلق مثل مئات البشر في بئره الذي لا قرار له، أخشى أن أنهار. أتمتم في نفسي لابد أن أقاوم”. وإذا كان أبطال قصص خالد غازي مثاليين في سلوكهم، فإن حل أزماتهم يتمثل في الترفع عن المادة والولوج إلى عالم الروح بما يحمل من روحانية ويقين. وهذا ما تجلى في خاتمة قصة “المارد الذي مات” “فكري صار خيمة بلا أوتاد، تتغلغل إغراءاته داخلي بفظاظة، أذرعة كأذرع الأُخطبوط، تعتصرني، صوته يهمس، يوسوس لي، أفقت عدت إلى إيماني أكثر صلابة، اتخذت قراري، مع أول شعاع للشمس، وجدته يتقهقر مخذولًا”.
وتجليات المكان تظهر واضحة في قصة “أحزان حارتنا القديمة” وفي “أحزان رجل لا يعرف البكاء”، “حين يغير النهر ألوانه”. فللمكان في القصة دلالة كبيرة، تتجاوز دلالة الموقف الشخصي المحدود، فقد يتسع المكان ليشمل الوطن أو يشمل العالم كله. ونجد أن الكاتب قد يتخلى عن نظرته المثالية ويتعمق في
بعض الدلالات الإنسانية كما في قصة “امرأة في الغربة”، حيث الضياع الذي تعاني منه بطلة القصة، فلا حاضر ولا مستقبل بعد أن فقدت أغلى ما يملكه الإنسان. وعن طريق المونولوج الداخلي يظهر العالم النفسي للشخصية، فتبدو المفارقة واضحة.
إن رؤية الكاتب وفق هذا التصور ذات طابع مثالي، فيها انتصار للخير واستشراف للحلم، وهزيمة للواقع المادي بما فيه من جشع وتحلل. ولكنني أرى أن هذه النظرة تنأى عن الواقع بما فيه من احتدام وصراع وعراقة بين قوى الخير والشر، بين الأبيض والأسود. كما أن الرؤية تبدو حلمًا لغويًا تصوره مفردات اللغة الخصبة أكثر مما هو واقع حي يعبر عنه بالفعل. إن الصراع بناءً على هذه الرؤية هو اتجاه واحد، يمكن أن يفسر مقدمًا وهو محسوم مسبقًا ما دامت كل الشخصيات خيرة منتصرة، مثالية، متجاوزة للواقع بتفاعلاته وعقدة وعلاقاته المتشابكة. ويبدو أن حياة القاص وثقافته الدينية قد أملت عليه هذه النظرة المثالية للحياة، ومن ثم أغرق نفسه في مجموعة من التصورات النظرية التي تعجز عن تقديم الحلول العملية لمشاكل الإنسان ومعاناته.
حقًا، إن الفن لا يقدم حلولًا أو إجابات لأسئلة، ولكنه يرصد الصراع المحتدم في النفس الإنسانية، ويكشف عراء المعاناة التي يواجهها الإنسان في تصديه للواقع وتغييره إلى الأفضل. الأداة التي استخدمها الكاتب في التعبير عن رؤيته المثالية للواقع هي لغة أدبية، يغلب عليها طابع الوصف كما في “المارد الذي مات”، “حين يغير النهر ألوانه”، “من أوراق امرأة تنتظر”. ولكنه يخرج عن هذا الإطار الوصفي إلى لغة شعرية يربط بها بين الطبيعة والشعور النفسي للشخصية، كما في قصة “وما يأتي” حيث تتآزر المشاهد الطبيعية والسلوكيات التلقائية مع جو التوتر.
وتبدو اللغة في بعض القصص ذات طابع رمزي لا يقصد بها معناها الوصفي، وإنما بدلالة عامة تشع من خلال السياق. ويبدو هذا – على سبيل المثال – في قصة “مع سبق الإصرار والترصد”، حيث الحوار بين طرف واقعي موجه وطرف رمزي مستوحى المغزى المستهدف، وهو تجاوز الواقع المهترئ إلى عالم مثالي تظلله الطهارة والفطرة والحقيقة. وإن كان سرد التفصيلات المادية للرمز قد أضعف من تأثيره الروحي المثالي، فالكاتب يجعل الرمز وهو (الحقيقة المثالية) امرأة، ولكنه يسرد أوصافها الحسية، وهذا يضعف من دلالة الرمز.
وهناك ظاهرة في لغة الكاتب، إلى جانب اهتمامه بالجمل الشعرية، هي توظيفه للتراث الديني، خاصةً القرآن الكريم والمقولات المأثورة، التي تتصدر مطالع قصصه وتتغلغل في ثناياها أيضًا. وهي اقتباسات قد وظفها الكاتب في التعبير عن الخط الدرامي والكشف عن التضاريس النفسية للشخصية. وقد نجحت اللغة في كثير من القصص في استبطان الشخصية والولوج إلى عالمها الداخلي ورصد القلق والتوتر والمعاناة، وهي ظاهرة طبيعية لكاتب يمارس الكتابة ويحاول جاهدًا أن تكون له شخصيته الفنية المميزة.
التقنية الفنية: نجد أن القاص قد نوع في استخدام التقنية الفنية، فقد استخدم السرد والحوار، وبنى معظم قصصه على ما نسميه المفارقة التصويرية، فهناك موقفان، أحدهما واقعي مادي والثاني أخلاقي مثالي، وغالبًا ما يحسم الصراع لصالح الموقف الثاني. كما استخدم الكاتب أسلوب الارتداد في بعض قصصه مثل “قالت أذكرني” و”أحزان رجل لا يعرف البكاء”. كذلك الإسقاط التاريخي المتمثل في شخصية الحجاج ومحبوبته في قصة “أحزان رجل لا يعرف البكاء” التي تحمل اسم المجموعة. ووظف أسلوب الرسائل والمذكرات والمونولوج الداخلي في الكشف عن العالم النفسي للشخصية. وقد وضح اهتمام الكاتب بالأقصوصة، التي تحتل مساحة ضئيلة قد لا تتجاوز الصفحة الواحدة، مثل “الطريق” و”الهزيمة” و”الصعود” و”المارد الذي مات”. وهذا الشكل الفني يتطلب قدرة كبيرة على التكثيف والسيطرة المحكمة على البناء الفني.
وهناك شكل فني حديث استخدمه القاص وهو تنويع المشاهد داخل القصة الواحدة، بحيث تبدو في الظاهر مجزأة ومنفصلة، ولكنها في النهاية تكون رؤية واحدة، هي تعميق موقف في حياة الإنسان، كما في قصة “لا تؤاخذني على صراحتي”. فالمشهد الأول “الطريق”، والثاني بعنوان “الهزيمة”، والثالث بعنوان “الصعود”، ولكن هذه المشاهد الثلاثة توضح أزمة الإنسان وصراعه مع واقعه الشرس وإنهزامه أحيانًا أمام قوى النفاق والتسلط والزيف، فيختفي وجهه الحقيقي ويتحول، ولكنه سرعان ما يبدو في ملامحه الحقيقية حين يقبل الصبح، رمز الأمل والوضوح والحقيقة. وهذا التقنيك استخدمه القاص في “أحزان رجل لا يعرف البكاء” و”الرهان على جواد ميت”، لكنه بدلاً من أن يعنون المشاهد قسمها إلى مقاطع مرقمة.
إن خالد غازي استطاع أن ينوع من تقنيته الفنية ويستفيد من الحداثة في كتابة القصة القصيرة ويطور أدواته الفنية، وإن كان لم يستفد ببعض التقنيات الحديثة كتوظيف الحلم واستخدام تيار الوعي وغموض الرمز. ولن يثري تجربة قاصنا سوى النظر إلى الواقع بجسارة وشمول، فلا نعلن النظرة المثالية التي تجعله بعيدًا عن الواقع المعاش بتفاعلاته المتناقضة، وحبذا لو التقطت بصيرته الضعف الإنساني، حينئذٍ يستطيع أن يثري تجربته القصصية ويقدم لنا رؤية جديدة لواقع زاخر بالأحداث.
د.عبد الفتاح عثمان
أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة