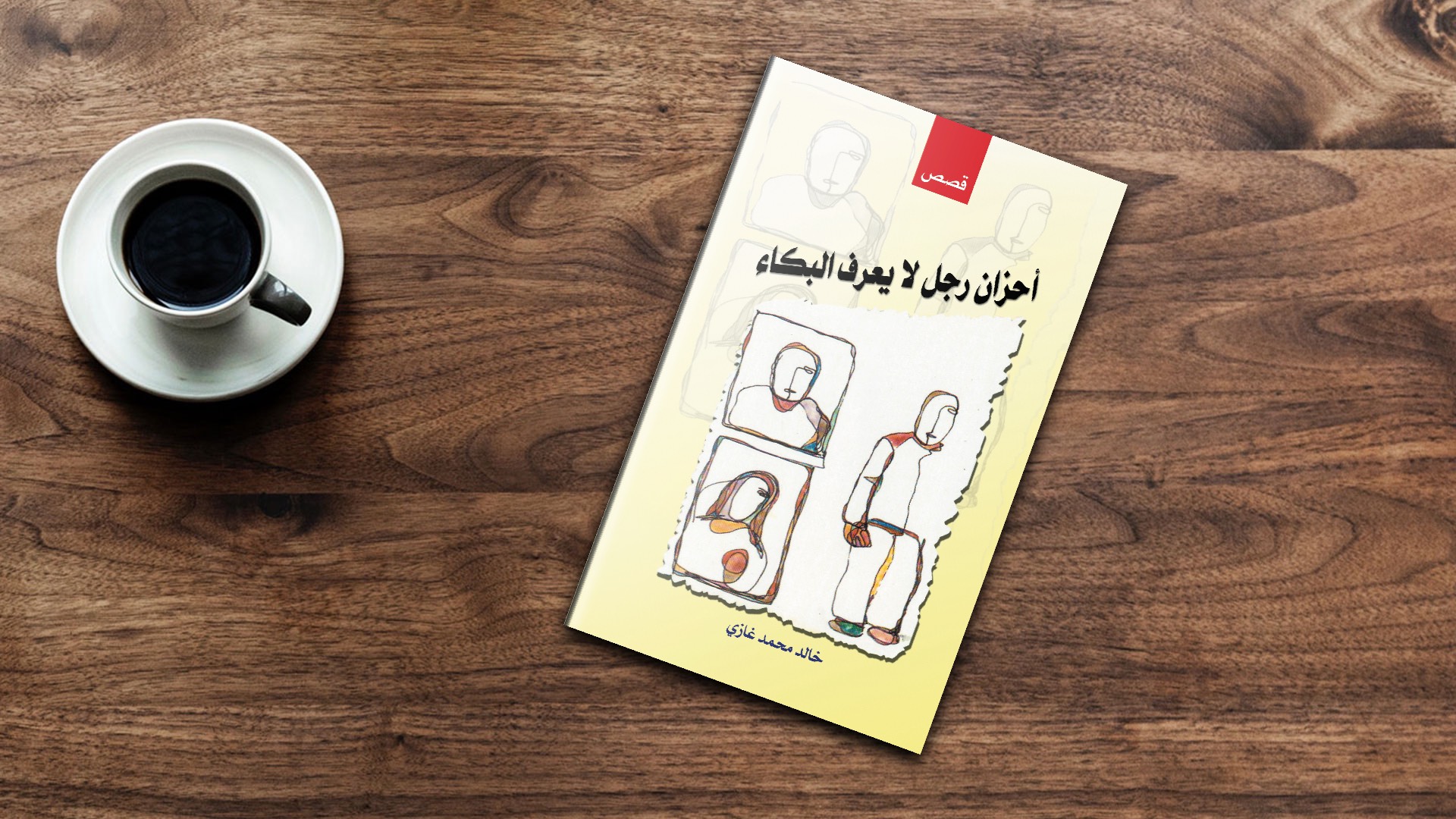
![]() د. عبد الفتاح عثمان –أستاذ النقد الأدبى بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة
د. عبد الفتاح عثمان –أستاذ النقد الأدبى بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة
هذه المجموعة ” أحزان رجل لا يعرف البكاء “هى التجربة الفنية الأولى للكاتب خالد غازى، وتتكون المجموعة من عشرين عملاً إبداعياً يتنوع بين القصة القصيرة والأقصوصة، وقد كتبها فى الفترة الممتدة من عام 1984-1987، وقد نشر الكاتب قصص هذه المجموعة فى الدوريات المصرية والعربية، والمجموعة تعالج قصصها مواقف فى حياة الإنسان المصرى البسيط تتجلى فيها أرمته الحقيقية فى صراعه الحاد بين المثال والواقع وهمومه الذاتية فى تجاوز واقعة المهتدئ نحو عالم القيم، وتجسد الحلم فى التغيير إلى ما هو أفضل. ويمكننا من خلال قراءة هذه المجموعة أن ندرك الخصائص المميزة للكاتب من ناحية الرؤية والأداة والتكنيك الفنى.
أولاً: الرؤية:
رؤية الكاتب تتسم بالمثالية والروح الرومانسية الشفافة التى تتجاوز الواقع المادى بتراكماته الهائلة من الضرورات التى تمسك بخناق الإنسان، وتكاد تعصف به، فى البيت حيث مطالب الزوجة والأولاد، والعمل حيث النفاق الأجتماعى، والصداقة الخالية من المبادئ والتى تؤثر المداراة ولكن الشخصية تحتفظ ببراءتها ونقائها وسط هذا الزيف، ويبقى الحب مخلصاً للطهر والشرف والكرامة ويستمر الحلم مستشرقاً، غداً فجر جديد، وهى القصة الأولى فى المجموعة، حيث تعلو الشخصية على متناقضات الحياة المادية، وما فيها من كذب ونفاق ومرواغة، فالزوجة تسأل زوجها: لماذا لا تفعل مثلما يفعل الأستاذ أحمد جارنا وزميلك فى العمل، فيجيب الزوج: أتريدين أن يدخل بيتى الحرام، لا.. هذا مستحيل. ورغم الظروف القاسية التى تحيط بالشخصية إلا أنها ترفض الحلم والظلم.
صمت المدير قليلاً ثم قال: لماذا لا تنظر إلى مستقبلك ومستقبل أولاد؟
تأملنى وابتسم ابتسامه لا أدرى معناها، غمز بإحدى عينيه، وقال: ستنال مقابل توقيعك مبلغاً لم تحلم به.
سيدى إن مصلحة العمل نل تكون على حساب إنسان برئ ومصلحة أولادى لن تكون بمشاركتى فيما يأباه على ضميرى..
أنظر قصة (غداً فجر جديد).
فهذه روح مثالية شفافة، تصطدم بالواقع المرير، فتستشرق الشخصية أفاق الحلم فى حوار مع الحقيقة التى تبقى دائماً بخلودها.
وحدى حزيناً ألعق اليتم العميق.. ترى هل أنا على حق؟
نعم.. أنت على حق؟
لكن لماذا؟؟ قاطعتنى.
لا تستعجل الفجر الجديد، الفجر يصنعه عشاقى.
أنا من عشاقك.
العشق صعب المرتقى.
أنت ملاذى وعشقى، وكل الأمانى.
أنظر قصة “غداً فجر جديد”.
وهذه المثالية نجدها فى كثير من قصص المجموعة، منها قصة شمس لا تغيب، والدواء، وعندما قالت: لا. فقصة عندما قالت: لا، بطلتها امرأة عانت كثيراً من قسوة زوجة أبيها إلى أن تزوجت من رجل ناجح وعاشا معاً فى سعادة إلى أن أصيب الزوج فى حادث أدى إلى عجز فى ساقيه، وبدأ الزوج يشك فى سلوكها، لكنها كانت على النقيض طاهر وفيه.
وإذا كان الكاتب ينظر للحياة هذه النظرة المثالية، فإنه يرى الحل فى الترفع عن المادة والولوج فى عالم الروح بما يحمل من روحانية ويقين، وهذا ما يتجلى فى قصو “شمس لا تغيب” حيث يعانى بطل هذه القصة من الأحساس باليأس فى الشفاء من آلامه الجسدية المبرحة، ولكن الأمل يشرف من خلال زوجته التى حملت الأمل فى أية من القرأن الكريم، كانت الشفاء لنفسـه، “قـل يا عبـادى الذيـن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله”، شرحت زوجته تأملاته، التفت إليـها، شعر أن الحزن بداخله يتخاذل، رويداً.. رويداً، أحس أنه قدار على أن يقف فى العراء، يسبح فى الماء، أحـساس ما، غمر روحه.. سرى فى حنايا جسده.. أنظر قصة شمس لا تغيب.
وعنصر الأمل القادم فى اللحظات الأخيرة هو الذى يشكل رؤية الكاتب فى “الطريق إلى سلوى” حيث شخصية عثمان رغم ما عاناه من معاناة وانتظار، مازال ينتظر الأمل بعودة سلوى، كذلك فى قصة الدواء، يتغير مسار القصة فى اللحظات الأخيرة، حيث يقتحم الأمل نفس البطل، وفى طريق الذكريات حيث بطلة القصة تشاجرت مع زوجها، فخرجت تمشى فى طريق كان لهما، هى وزوجها فيه ذكريات، إنه نفس الطريق الذى سارا فيه معاً فى تلك الأيام الحلوة وهما يحلمان بالسعادة التى تنتظرهما بعد الزواج، ويبرز دور المكان، فيكون طريق الذكريات هو الجامع للزوجين بعد هجر وخصام.
أما قصة الطريق إلى سلوى فتبدو كأنها اسطورة، صبية تعين حالة اكتئاب بلا سبب ولا مبرر يبرزه الكاتب، منذ طفولتها المبكرة وعثمان يتقرب إليها، لكنه لا يجد منها سوى الصد والإعراض، فى حين يطوف والدها بها عيادات الأطباء ولما يأس بدأ يعرضها على الدجالين، ولا فائدة ترجى ويعتزم عثمان على الزواج منها، لكنها تختفى ليلة عرسها، ورغم ذلك فعثمان مازال ينتظرها، فتحولت سلوى من مجرد فتاة مخبولة إلى رمز.
وإذا كانت الخرابة تمثل مكاناً تدور فيه أكثر أحداث قصة، الطريق إلى سلوى، فإن المكان أيضاً هو السلوى للصبى فى قصة الأضواء الشاحبة، حيث يتعرض لقسوة زوجة الأب بعد أن فقد حنان الأم، ومن خلال الممارسة القاسية يهرع الطفل إلى الدار القديمة مطون ذكرياته مع أمه.
“قادته قدماه إلى مكان يعرفه.. مكان له نفس ذكريات لا تنسى.. نعم .. بجوار هذا المسجد الكبير كانت دارهم القديمة قبل وفاة أمه، وقف أمام الدار.. يحملق فيها.. أحساس غريب ينتابه.. يستحوذ على كيانه.. أغروقت عيناه بالدموع وهو يتطلع إلى الدار بحزن، الألم الذى تجرعه غرس فى نفسه مرارة الحرمان، فى تثاقل جرجر قدميه واستدار مشى بضع خطوات ثم توقف، لوى عنقه والتوى معها قلبه المحروم، تجاه الدار القديمة، أنظر قصة الأضواء الشاحبة.
وتجليات المكان على الشخصية تظهر أيضاً فى قصة الدواء حيث يذهب بطل القصة إلى موطن ذكرياته فى الصبا، وهو حى الحسين، ويتعاظم دور المكان فى قصة الموت مرة أخرى، حيث الأرتباط بالأرض ورفض الهجرة إلى المدينة ثمناً للزواج فيضحى المكان قيمة يدافع الإنسان عنها.
وللمكان فى القصة دلالة ومكانة كبيرة، تتجاوز دلالة الموقف الشخصى المحدود، فقد يتسع المكان ليشمل الوطن أو يشمل العالم كله. ونجد أن الكاتب قد يتخلى عن نظرته المثالية ويتعمق فى بعض الدلالات الإنسانية، كما فى قصة الحرمان، حيث يقارن بين حال الشخصية فى ليلة زفافها وبين حال أمه ووفاة أبيه، وعن طريق المنولوج الداخلى يظهر العالم النفسى للشخصية، فتبدو المفارقة واضحة من خلال المفردات المادية بين حياة بهيجة متألقة فى الحاضر وحياة حزينة قاتمة تتوازى مع الحاضر هى حياة أمه التى ادت واجبها وضحت فى صمت.
كذلك الحال فى بطل قصة “رفقاً أيها الزمن” فبطل القصة يعانى من الوحدة القاسية، فترتد به الذاكرة إلى الأمس القريب حيث أبنائه الذين كبروا وأصبح لكل منهم حياته الخاصة به وبقى هو وحيداً لا عزاء له سوى الذكريات.
غير أن أكثر قصص هذا الاتجاه الإنسانى تأثيراً هى قصة “على حافة العودة” وفيها يعالج القاص موقفاً فى حياة انسان بسيط هو بواب لعمارة، يحمل أشياء ثقيلة إلى الطابق الخامس عشر ثم يهبط مرة أخرى ببقية الأشياء، وهو يحلم فى مكافأة تتوازى مع معاناته، ولكن المأساة فى أن السيدة صاحبة الأشياء التى حملها تكافئه بوجه متجهم وسباب ثقيل ثم تتضاعف المأساة حين “خرج ابنها الصغير من احدى الحجرات وفى يده كرة، قذفها فى وجه البواب وهو يصرخ مبتسما”.
وبهذا جسد الأنكسار والإحباط، خاصة عندما يسهم الطفل رمز البراءة والطهارة فى تعميق الإحساس بالظلم عند هذا الإنسان البسيط، وهذا الظلم نجدة فى أقصوصة “إلى أين؟” فبطلة القصة تسير فى الطريق وحولها الظلام الحالة والدنيا منكمشة أمام عينها، فمنذ قليل ضبطت زوجها فى أحضان الخادمة، إنها تتساءل: هل أستسلم للواقع الحزين؟ وتعود لزوجها من أجل أطفالها الثلاثة أم تستلم لذلك الشاب الذى يطاردها بسيارته. وكما سبق وان أشرنا أن الكاتب مؤمن بالمثالية وبتأثير المكان وتأثير الدين، وأنه يرى أن الخروج على هذه الأقانيم يؤدى إلى السقوط، وهذا ما نجده فى قصة الصعود إلى أسفل، امرأة فى الغربة. وإذا كان الإنسان قادراً على الأنتصار على نوازع نفسه كما فى قصة، “المارد الذى مات” فإنه كإنسان يعانى داخل نفسه من القوى التى تحاصره وتضعط عليه كما فى “الطريق والهزيمة والملامح القوية”.
إن رؤية الكاتب بناء على هذا التصور ذات طابع مثالى فيها انتصار للخير، واستشراق للحلم، وهزيمة للواقع المادى بما فيه من جشع وتحلل، ولكن هذه النظرة تبتعد عن الواقع بما فيه من أحتدام بين قوى الخير والشر، ويبدو الحل سهلاً فى هذا التصور، فما هى إلا أيات من القرأن تسمع، او مشاهد من المكان ترى حتى تتحول الشخصية من النقيض إلى النقيض، وهى رؤية مسطحة تبتعد عن الواقع الإنسانى بما فيه من توتو وصراع، كما أن الرؤية تبدو حلماً لغوياً تصوره الكلمات أكثر مما هو واقع حى، يعبر عنه الفعل، إن الصراع بناء على هذه الرؤية هو أتجاه واحد، يمكن أن يفسر مقدماً وهو محسوم مسبقاً مادامت كل الشخصيات خيرة منتصرة ومثالية، متجاوزة للواقع بتفاعلاته المعقدة وعلاقاته المتشابكة.
ويبدو أن حياة القاص فى ريف دمياط وثقافته الدينية قد أملت عليه هذه النظرة المثالية للحياة، ومن ثم لم ير لها إلا وجهاً واحداً، فأغرق نفسه فى مجموعة من التصورات النظرية التى تعجز عن تقديم الحلول العملية لمشاكل الإنسان ومعاناته.
حقاً إن الفن لا يقدم حلولاً أو إجابات ولكنه يرصد الصراع المحتدم فى النفس الإنسانية ويكشف عراقة المعاناة التى يواجهها الإنسان فى تصدميه للواقع وتغيره إلى الأفضل.
ثانياً: الأداه:
استخدم الكاتب فى التعبير عن رؤيته المثالية للواقع لغة أدبية، يغلب عليها طابع الوصف كما فى “شمس لا تغيب”، “الطريق إلى سلوى” ، “طريق الذكريات”، “رفقاً أيها الزمن”، “الدواء” ، الموت مرة أخرى، ولكنه يخرج عن هذا الأطار الوصفى إلى لغة شعرية يربط بها بين الطبيعة والشعور النفسى للشخصية كما فى قصة “الأضواء الشاحبة” حيث تتأزر المشاهد الطبيعية مع شعور الطفل الحزين، وهو يسترجع ذكرياته فى دار أمه التى كانت موطن الحنان والعطاء ثم حرم منها لفقد أمه.
فى تثاقل جرجر قدميه واستدار، مشى بضع خطوات ثم توقف، لوى عنقه والتوى معها قلبه المحروم، تجاه الدار القديمة، فى الظلام الدامس أرتعش نجم صغير فى ركن منزو من السماء، المصـابيح البرتقالية الشاحبة تلقى بظلال أعمدتها على الطريق، الأضواء الشاحبة، مرتجفة، قفل الصبى عائداً من حيـث أتى وهو يحاول تجفيف دموعه.
وتبدو اللغة فى بعض القصص ذات طابع رمزى لا يقصد بها معناها الوصفى، وإنما توحى بدلالة عامة تشع من خلال السياق، ويبدو هذا على سبيل المثال، فى قصة “غداً فجر جديد” حيث الحوار بين طرف واقعى موجه، وطرف رمزى مستوحى المغزى المستهدف وهو تجاوز الواقع المهتدئ إلى عالم مثالى تظله الطهارة والفطرة والحقيقة، وإن كان الإلحاح على سرد التفصيلات المادية للرمز قد أضفت من تأثيره الروحى المثالى، فالكاتب يجعل الرمز، وهو “الحقيقة المثالية” امرأة ولكنه يسرد أوصافها الحسية، “امرأة جميلة، ترتدى رداء أبيض، شعرها كثيف أسود.. وجهها يشرق من وسط هالة شعرها الكثيف. وقد أضعف من دلالة الرمز هذا التكرار لوصف الشعر، إلا أذا كان يقصد الحقيقة المضيئة التى تلمع من خلال الظلام الكثيف الذى يحيط بها.
وقد نجح الكاتب فى توظيف الرمز فى قصة “الصعود إلى أسفل” حيث بدا السلم رمزاً، حيث صعدت إليه بريئة ونزلت منه بغياً ساقطة، فأضحى السلم رمزاً لدلالة أخلاقية.
وهناك ظاهرة فى لغة الكاتب بجانب اهتمامه بالجمل الشعرية، هى توظفيه للتراث الدينى خاصة القرأن الكريم، حيث نجد هذا التعبير، “إن بعد العسر يسراً”، وإن كانت الأية الكريمة، “فإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا”، وأيه “قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله”.
وهى أقتباسات وظفها الكاتب فى التعبير عن الخط الدرامى والكشف عن التضاريس النفسية للشخصية.
وعلى كل حال فإن اللغة عند الكاتب لم تنجح فى بعض الأحيان، من استبطان الشخصية والولوج إلى عالمها الداخلى، ورصد القلق والتوتر والمعاناة، وهى ظاهرة طبيعية لكاتب يمارس الكتابة ويحاول جاهداً أن تكون له شخصيته الفنية المميزة.
ثالثاً: التكنيك الفنى:
نجد أن الكاتب قد نوع فى استخدام التكنيك الفنى، فقد استخدم السرد والحوار، وبنى معظم قصصه على ما نسميه المفارقة التصويرية، فهناك موقفان أحدهما واقعى ومادى والثانى أخلاقى مثالى، وغالباً ما يحسم الصراع لصالح الموقف الثانى، كما استخدم الكاتب اسلوب الأرتداء فى بعض قصصه مثل الحرمان أحزان رجل لا يعرف البكاء، كذلك الاسقاط التاريخى المتمثل فى شخصيه الحجاج ومحبوبته فى قصة أحزان رجل لا يعرف البكاء.
ووظف المنولوج الداخلى فى الكشف عن العالم النفسى للشخصية، وإن كان تركيزه على المنولوج الخارجى الذى يوضح المواقف المفارقة.
وقد وضح اهتمام الكاتب بالأقصوصة، وهى التى تحتل مساحة ضئيلة قد لا تتجاوز الصفحة الواحدة، أنظر “الموت مرة أخرى” ، “المارد الذى مات” “الصعود إلى أسفل”، وهذا الشكل الفنى يتطلب التكثيف والسيطرة المحكمة على البناء الفنى.
وهناك شكل فنى حديث استخدمه القاص وهو تنويع المشاهد داخل القصة الواحدة، بحيث تبدو فى الظاهرة مجزأة، منفصلة، ولكنها فى النهاية تكون رؤية واحدة، وهى تعميق موقف فى حياة الإنسان، كما فى قصة “الطريق والهزيمة والملامح القوية”، فالمشهد الأول “الطريق” والثانى بعنوان “الهزيمة” والثالث بعنوان “العودة إلى الملامح القديمة” ولكن هذه المشاهد الثلاثة توضح أزمة الإنسان وصراعه مع واقعة الشرب وانهزامه أحياناً أمام قوى النفاق والتسلط والزيف، فيختفى وجه الحقيقى ويتحول، ولكنه سرعان ما يبدو فى ملامحه الحقيقية حين يقل الصبح رمز الأمل والوضوح والحقيقة.
وهذا التكنيك استخدمه القاص فى “مقاطع من بكائيات” لكنه بديلاً من أن يعنون المشاهد قسمها إلى مقاطع مرقمة.
إن خالد غازى استطاع أن ينوع من تكنيكه الفنى ويستفيد من الحداثة فى كتابة القصة القصيرة ويطور ادواته الفنية، وأن كان لم يستفد ببعض التقنيات الحديثة، كتوظيف الحلم، واستخدام تيار الوعى وغموض الرمز.
وهو بمجموعة القصصية الأولى يبشر بقصاص واعد، لا ينقصه سوى إحكام سيطرته على البناء الفنى، فل يخضع النهايات للحلول الخارجية، ولا يجعل منطق الأحداث خاضعاً للصدفة، ويتعمق فى تصوير الصراع الدامى وينظر إلى الواقع بجسارة وشمول.
فلا تغلبه هذه النظرة المثالية التى تجعله بعيداً عن الواقع الموضوعى بتفاعلاته وتناقضاته وحبذا لو التقطت بصيرته فى أعماله القادمة، مواقع الضعف الإنسانى وسجل نبضها بين أبناء الريف المصرى الذى هو واحد منهم، حينذاك يستطيع أن يثرى تجربته القصصية ويقدم لنا رؤية جديدة للواقع الذى عاش فيه.