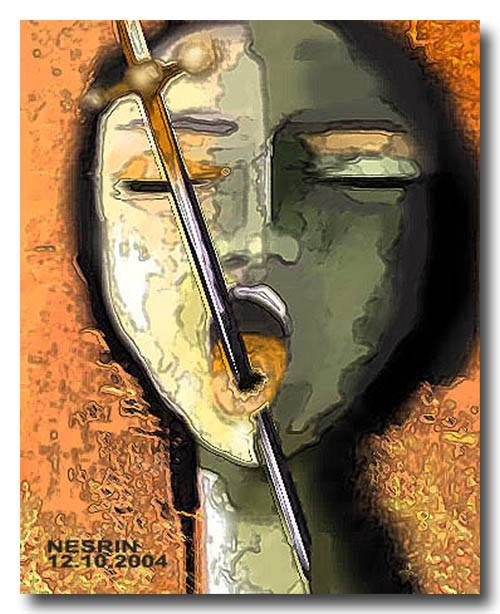

د. خالد محمد غازي
تتداعى الأحداث وتتجلي مظاهرالاحتجاجات في شكل اعتصامات وتظاهرات في عواصم عربية عدة بأشكال مختلفة؛ أشعلتها ” ثورة الياسمين ” بتونس وتتصاعد وتيرتها ساعة بعد أخرى، فطالت الاردن واليمن ومصر.. وعواصم أخري النار فيها تحت الرماد .. والسؤال الذي يطرح نفسه علي الحكومات العربية : لماذا يتظاهر الناس ؟
والاجابة لدي الحكومات جاهزة ” المتظاهرون خونة ومرتزقة وتحركهم جهات أجنبية للنيل من استقرار البلاد والانجازات التي تحققت ” .
هل علينا أن نقنع بهذا التبرير؟ الاجابة المنطقية الموضوعية : ان الناس لم تجد أذنا صاغية لرأيها ومشاكلها؛ ففاض بهم الكيل ؛ فخرجوا يحثون الخطي نحو التغيير ؛ والتعبير عن رأيهم ؛ فلم يعد السكوت ممكنا والبطون خاوية والافواه مكممة حتي من الصراخ .. ولم يعودوا يقنعون باشباع جوعات عارضة – من قبل حكامهم – أو تغييرات سياسية تجميلية ؛ أو ولاءات زائفة . إن ما حدث تونس سيؤثر حتماً على الشعوب العربية ، ويدفعهم لحرية التعبير، ولن يكتفوا بالتغييرات الجزئية والشكلية والاذعان لمنطق ” ليس في الامكان أفضل مما هو موجود ”
(1)
ان لحرية الفرد أهمية مكتسبة؛ نظرًا لالتصاقها بالتحقق الإنساني الدائم والمنشود، استنادًا إلي وعي الإنسان لذاته المهمومة دائمًا بوجودها؛ سواءً تاريخيا أو كونيًا. وتباعًا للفعل الإنساني، فإن تلك الذات المهمومة تشكل “شرط تقدم”، يضفي علي الفرد وعياً لذاته، ليرى نفسه مجسدًا لمعاني الحرية السامية.
حرية الإنسان تعني تمكينه – دون جبر أو ضغط خارجي – من اتخاذ قراراته، أو تحديد خياراته، وهذا ما أكده الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية التي تنال من كرامته .. كما أن لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية وأن يُكفل لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية، التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
إذن، فحرية الفرد من الحقوق الطبيعية، التي لا يجوز تقييدها إلا بنص قانوني ومعايير محددة وفق ظروف معينة، وحسبما نصت اتفاقية الأمم المتحدة – والمسماة بـ”اتفاقية حقوق المدنية والسياسية”، فإن الحرية الفردية، تعني: أحقية المواطن في أن يحيا فى بلده آمناً من الاعتداء على نفسه، أو ماله، أو شرفه؛ في إطار ضمانات بعدم القبض عليه، أو توقيفه، أو معاقبته إلا بمقتضى القانون؛ بما يصون له حرية التصرف في شئونه الخاصة؛ شريطة ألا يكون في تصرفه عدوان على حقوق الغير.
(2)
ومن واقع “حرية الفرد” تندرج قدرته على المشاركة السياسية، ليتبدي دور ممارسة “الحرية السياسية” في الأفق المجتمعي، بوصفه حلمًا يبحث عنه ملايين البشر فى المجتمعات العربية المختلفة؛ فالممارسة السياسية للفرد من شأنها بناء مجتمع شامخ متسلح بفكر سياسي يقوم على صون: الحريات، والديمقراطيات، وحقوق الإنسان.
ورغم تلك الضروريات، فإن مفهوم “الحرية السياسية للفرد” لا يزال يعاني فى مجتمعاتنا العربية أشد الضغوط، حتى بات الحديث عنه جريمة يعاقب عليها القانون؛ بل إن المطالبة به تعد تعديًا على الحكومات، الأمر الذي استتبعه تخلف الفرد عن ممارسة حقه السياسى ومصادرة إرادته، وقمع حريته المشروعة، مما صاحبه بعض المطالبات المتكررة بضرورة بث الروح من جديد في مصطلح “حرية الفكر” المتجمد، وتحرر العقل من الإرهاب الفكرى، بما يفسح المجال للفرد لينطلق ويفكر ليبدع؛ إذ أغلب الدراسات – بل والأعراف – تشهد بأن الانسان المقيد فكرياً هو إنسان مشلول الإرادة.
(3)
شهد التاريخ البشرى في القرون الثلاثة الماضية مفهوماً ومصطلحا حديثاً في الحياة الفكرية والمجتمعية، وهو “الديمقراطية”، والذي ينضوي تحت فلسفة سياسية للتعايش المشترك في المجتمع بشكل سلمي؛ ترتكز علي استقلالية الفرد وحريته وعقلانيته، بل وسلوكه المتحضر مع بقية أفراد مجتمعه في إطار مجتمع منظم.. فلسفة رائدة تنبني علي تجارب إنسانية متعددة، ومتعلقة بشرعية السلطة السياسية، لتنمو علي أثر ذلك بشكل تدريجي بالفكر والتطبيق، والمقارنة مع تجارب الشعوب المختلفة، حتي تصل بالفرد إلى مراتب عالية في حياة هانئة.
إلا أن ذاك الوافد الجديد المسمي ” الديمقراطية ” ليس في حقيقته ثوبًا يفصله المفكرون لتلبسه الشعوب؛ لتسيير أمورهم السياسية والاجتماعية بشكل آلي، لكنها في الأصل تجربة إنسانية استطاعت أن تحقق نجاحات وطفرات كبيرة؛ عكست متطلبات الإنسان في العصر الحديث؛ لذا فإنه كانت الحاجة ملحة للأخذ بها للعيش في مجتمعات أكثر حرية؛ في محاولة للخروج تدريجيا من ظلمات “الديكتاتوريات “، ومن غياهب التقاليد الاستبدادية المتوارثة في المجتمعات العربية.فهذه الديمقراطية ليست شكلا في أسلوب الحكم فقط، بل هي ثقافة سياسية واجتماعية، تؤثر في المؤسسات السياسية، والاقتصادية والقضائية والدينية لترسيخ حقوق الإنسان العربي.. فضلًا عن أنها سلوك جماعي يحتاج إلى ركيزة واسعة من المواطنين الواعين لأمورهم ويريدون العيش بحرية، دون الارتكان إلي مخاوف سلطوية تهددهم ؛ بما يفرض علي الشعوب النأي بعيدا عن العصبية والسلطوية؛ والخلافات الممكنة والطبيعية في عالمنا الإنساني.
(4)
الديمقراطية تصنع – بتمكينها الفرد من المشاركة فى الحياة السياسية – نوعًا جديدًا من الحكومات، “حكومات ديمقراطية” تمارَس فيها السلطة والمسئوليات المدنية، بواسطة المواطنين كافة، بصورة مباشرة أو عبر مندوبين عنهم – يتم انتخابهم بحرية.. إذ إنها تقوم على أساس حكم الأغلبية المقرون بحقوق الفرد والأقليات، مع احترام إرادة الأغلبية، والتي تحمي الحقوق الأساسية للفرد والأقليات، لتلعب فى الوقت ذاته دور الحارس الذي يحول دون تغول نظام الحكم ليتحول إلى حكومة مركزية تمتلك كل السلطة، غير متفهمة لضرورة الاستجابة لاحتياجاتهم الشعوب ، فالديمقراطيات في شتي المجالات تحتاج إلى بيئة حرة ونزيهة حتي تتيح للفرد المشاركة الحرة؛ بدءًا من الانتخابات الديمقراطية، التي لا يمكن أن تكون واجهة لنظام دكتاتورى، فضلًا عن حزب ينفرد بالحياة السياسية، ويتخفى وراء قناع الديمقراطية.. لذا أكد عدد من متتبعي الشأن السياسي العربي أن المسئولية تقع على الفرد في ظل هذا المفهوم الديمقراطي، ليتيح لنفسه المشاركة الفعالة فى النظام السياسى، وألا يكتفى فقط بحقوقه الشخصية المكتسبة والتي تكون عرضة لأن تسحب منه في أي لحظة .
(5)
وتباعًا لإغفال الجوهر الحقيقي للديمقراطية، فإن التذمر والتعبير عن الغضب ضد الحكام والحكومات أصبح ظاهرة متفشية، في ارتباط لا يحتمل الفصل بين الواقع المعاش والضغوط الاقتصادية والسياسية المهترءة ؛ لذا شهد العصر الحديث عدة ثورات متباينة، كان لها كبير الأثر فى تغيير الأنظمة الحاكمة؛ هدفت إلي تحقيق تغيير جذري للنظام الاجتماعي في الدولة، إلا أن معظمها كان بدافع سياسي؛ يحاول من خلاله المواطنون الانقلاب على الحكومة بهدف تبديلها بأخري جديدة.
ومن الجلي أن تلك الاحتجاجات السياسية اتسمت في غالبها بطابع العنف، ورغم تأكيد العديد من المفكرين السياسيين علي عدم وجود تفسير قطعي يجعل الامم تثور علي حكوماتها، إلا أن علماء اجتماع يؤمنون بأن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي الى انفجار بركان الغضب الشعبى؛ منها: الظلم، والحرمان السياسى، ناهيك عن الوضع العام فى المجتمعات المقهورة.